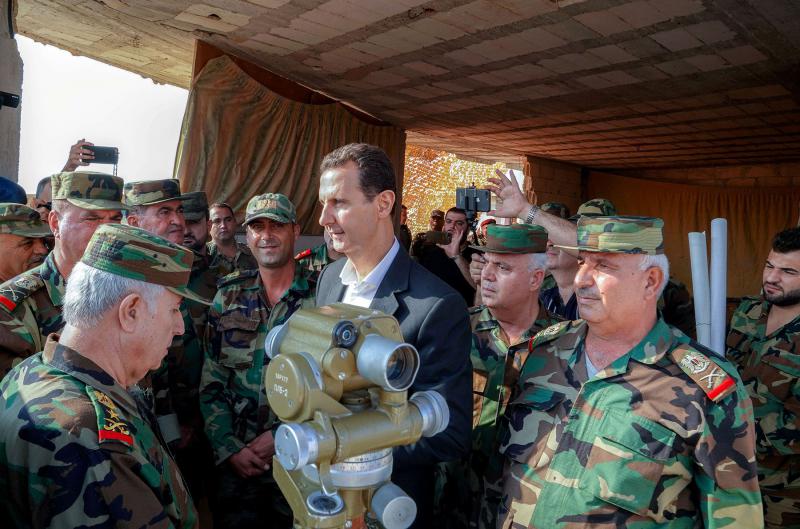هتف المحتجون في ساحة السير/الكرامة بالهتاف المعروف “سوريا لنا وما هي لبيت الأسد”، ثم أنهوا وقفتهم الاحتجاجية بالدعوة إلى الإضراب العام بدءاً من يوم الأحد المقبل. وكانت مدينة السويداء وأريافها قد شهدا إضرابات جزئية هي الأبرز، بدعم محدود من الجارة درعا، تلبيةً لدعوات متفرقة إلى الإضراب العام، أعقبت زيادة رواتب موظفي القطاع العام بعد رفع أسعار الوقود بنسبة تفوق الزيادة، ما نُظر إليه كاستهانة إضافية من قبل الأسد بمعاناة محكوميه الذين كانوا ينتظرون إجراءات اقتصادية من نوع مغاير كلياً.
تحرّكُ أهالي السويداء وعدم قمع احتجاجاتهم غير جديدين، وهذه أشبه بالمعادلة التي تم تكريسها خلال سنوات، رغم محاولة مخابرات الأسد الانقلاب عليها في العديد من المناسبات. بهذا المعنى، لا يأتي بجديدٍ دراماتيكي خروجُ بعض أهالي السويداء للتظاهر والتزام نسبة أكبر بالإضراب. فالأعين أصلاً متوجهة إلى الساحل السوري، لمعرفة أثر المجاعة الحالية وما إذا كانت ستدفع أبناءه إلى الاحتجاج، خاصة لأن الأسابيع الأخيرة شهدت تذمّراً علنياً “جريئاً” من موالين أو شبيحة سابقين، وشهدت أيضاً الإعلان عن حركة 10 آب التي يمكن القول أن صداها الرمزي أعلى بكثير من فعاليتها. فالحركة شاركت في الدعوة إلى إضراب يوم الخميس من دون أن تلقى الاستجابة على امتداد سوريا بموجب خطابها، أو في الساحل تحديداً حيث يرى كثر أن انتفاضة أبنائه “إن حدثت” هي أخطر ما يهدد سلطة الأسد.
تنطلق الدعوات إلى الاحتجاج من أنه لم يبقَ لدى السوري ما يخسره، بينما الإضراب “وصولاً إلى العصيان المدني” يهدد الأسد في حاضنته الشعبية؛ العلَوية كما يراها البعض والموالية عموماً كما يراها البعض الآخر. إجمالاً تنطوي الدعوات على منسوب من التفاؤل بأن يحظى التحرك المنتظر بقاعدة وطنية شاملة، والتفاؤل بأن الأسد لن يكون قادراً على مواجهة الاحتجاج الشامل بالتجاهل أو الإنكار وصولاً إلى العنف.
لكننا نفضّل عدم مسايرة النوايا الثورية النبيلة حتى النهاية، وما سنسوقه في مواجهتها ينطبق على النوايا “الإصلاحية” لدى شريحة تتمنى تغييراً في سلوك الأسد مع استعدادها للدفاع عنه إذا استشعرت خطر إسقاطه. فإذا افترضنا مثلاً أن مدن وبلدات الساحل السوري شهدت إضراباً عاماً بدءاً من الأحد المقبل، فهذا لا يعني حتميةَ تشجُّع حلب ودمشق وحماة وباقي المدن والبلدات على الإضراب، ومن المحتمل بنسبة 50% على الأقل أن تفشل فكرة الإضراب العام.
نفترض هنا عدم ممارسة ضغط روسي أو إيراني لتلبية مطالب المحتجين، وفي هذه الحالة يبدو سلوك الأسد متوقعاً لجهة استخدام كافة وسائل العنف لكسر إرادة هؤلاء الذين لا يشكّلون خطراً مباشراً على حكمه. والمفارقة المرّة في الحالة السورية أنه، إذا واتته حكمةٌ من قبيل إهمال المضربين ومطالبهم، لن يخسر شيئاً، بل قد يظهر من موظّفيه الكبار مَن يقول أن هؤلاء المضربين يوقفون المرافق التي تخدمهم لا غير.
لا نعلم من أين أتت فكرة ممارسة ضغط سلمي على الأسد، بحيث تتسع دائرة الضغط ويشتد ليضطر إلى تقديم تنازلات. فأدنى خبرة تفيد بأن الأسد لن يقف متفرجاً على حركة الاحتجاج وهي تتسع، وأنه سيتصرف بحيث يمنع توسعها، أي بممارسة أشدّ أنواع الترهيب والتنكيل، ربما في الساحل قبل غيره لتكون رسالته أقوى. إن كل ما هو أدنى من تحرك خاطف سريع، يشلً قدرة الأسد على المبادرة، سيفسح فرصة له كي يستجمع قواه وينتصر بحلفاء الخارج قبل الانتصار بشبيحته. هذا يعني، مع الأسف، أن الدعوات الطيبة قد تودي ببعض ممن يلبّونها إلى الموت المجاني.
ولأن الخيار السلمي “المأمول” تراكمي بطبيعته، ما يتيح للأسد استجماع قواه واللعب على تباينات محكوميه، ولأن الخيار العسكري الذي جرّبته المعارضة مستحيل فوق كارثية ما وصل إليه، يبقى الاحتمال الوحيد الذي لا نستطيع نفي إمكانية حدوثه، ولا التعويل على العكس، هو انقلاب عسكري مفاجئ، لا يطيح الأسد وحده، بل ينقلب أيضاً على معظم المعطيات التي تبدو اليوم راسخةً. بموجب ما سبق كله، يكون أعلى إنجاز يمكن للنضال السلمي تحقيقه هو تحفيز ضباط في الحلقة الضيقة جداً المقرَّبة من الأسد للانقلاب عليه، من دون أن نعتبر الانقلاب نتيجة حتمية لـ”ثورة الساحل”، ومن دون التعويل على عدم إدراك الأسد لهذا الاحتمال.
من جملة المعطيات التي ينهيها حدوث الانقلاب هو السؤال الدولي المزمن عن مصير الجيش والمخابرات، أو بالأحرى السؤال المزمن عن الجهة القادرة على ضبط الاثنين في حال نُحِّي الأسد، وبحيث لا يتكرر السيناريو العراقي حتى إذا كان قد حدث ما هو أسوأ منه! ذلك فضلاً عن أن سيناريو الانقلاب ينهي السؤال، الذي يُطرح عادة وينطوي على الإجابة أو يوحي بها، عن احتمال الانفلات الأمني وانتشار عمليات ثأر طائفية واسعة النطاق.
ولكي لا يبقى عزل الأسد شأناً يخص فقط محكوميه ومناطق سيطرته، يلزم شيء من النضج لدى الذين يسيطرون على باقي المناطق بحماية دولية وإقليمية. فائتلاف المعارضة أصدر بياناً يوم الخميس تحت عنوان “لا يمكن حل الأزمات في سوريا إلا بالتخلص من نظام الأسد”، والبيان يعيد الكلام المعهود عن مسؤولية الأسد، مكرراً دعوة المجتمع الدولي إلى إدراك ذلك (!) وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، مع العلم أن الائتلاف قبِل ضمناً تفسير القرار بأنه في أقصى حالاته لا يستثني الأسد من المشاركة في المستقبل.
أما الإدارة الذاتية المسيطرة على شرق الفرات فأعلنت يوم الجمعة “مبادرة لحل الأزمة السورية”، تغلّب على العديد من بنودها الهاجس الكردي فنال الحكم التركي مساحة وتشريحاً يزيدان بكثير عمّا ناله حكم الأسد، ولم تكن هناك إشارة إلى قوى الاحتلال الأخرى “إيران مثلاً” ولو من ضمن مطالبة عمومية برحيل كافة قوى الاحتلال. طرحت الإدارة تجربتها نموذجاً للحكم في سوريا ككل (!)، ولم تستثنِ الأسد من الحل، بل خاطبت المبادرة سلطته في بعض بنودها.
يُحسب للإدارة الذاتية تأكيدها مرتين على الحل في إطار وحدة وسلامة سوريا، وهذه نقطة لها حساسيتها لدى المتوجسين من نوايا كردية انفصالية. إلا أنه من الأفضل عدم اقتصار هذا التأكيد على الأكراد، فجزء من عزل الأسد يكون بتشجيع إطاحته مقابل عودة وحدة الأراضي السورية، على أن يأتي البديل عنه بمشروع للتحوّل الديموقراطي، وأيضاً مقابل تعهد المعارضة وقسد بضبط فوضى السلاح، وهي رسالة للعالم المتخوف من فوضى عسكرية مثلما هي للمتخوّفين من فوضى أهلية وثارات.
ربما يحين وقت الانقلاب على الأسد عندما تصبح بيئة ما كان يُسمّى بالموالاة جاهزة تماماً للتخلي عنه، وعندما تتضافر معها الحوافز من خارجها، خاصة لما تعنيه وحدة سوريا من ضرورات اقتصادية تعلو على ما هو رمزي أو عاطفي. لقد بذل الأسد الأب أقصى جهد ليكون انقلابه هو الانقلاب الأخير في البلاد، وربما يمرّ استرجاع سوريا من وريثه بعودتها لتكون بلد الانقلابات.
المواد المنشورة والمترجمة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة السورية.نت